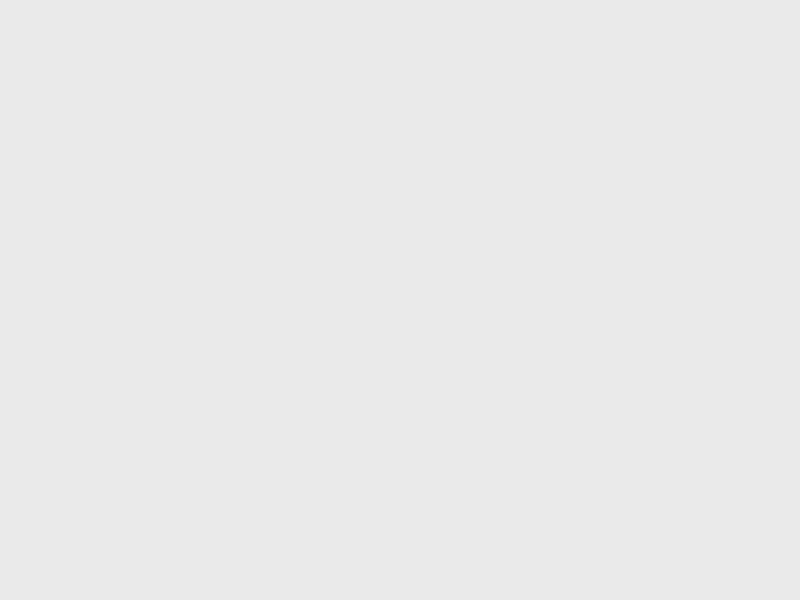ضرورة معرفة القرآن
معرفة القرآن لكل شخص بعنوان إنه إنسان عالم، ولكل مؤمن على أساس أنه فرد مؤمن، أمر واجب وضروري.
أما بالنسبة للعالم الخبير بشؤون الناس والمجتمع، فمعرفة القرآن ضرورية، لأن هذا الكتاب عامل مؤثر في تكوين مصير المجتمعات الإسلامية، بل، وفي تكوين المجتمعات البشرية. نظرة إلى التاريخ توضح لنا هذه النقطة، وهي أنه لا يوجد كتاب في التأريخ، أثر كالقرآن في حياة الإنسان، وفي تكوين المجتمعات البشرية (وأما في أي اتجاه كان هذا التأثير؟ وهل حول مسيرة التأريخ إلى جهة السعادة ورفاهية البشرية أم إلى جهة الانحطاط والنقص؟ وهل كان بسبب تأثير هذا القرآن، أن وجدت حركة وثورة في التأريخ، وجرى دم جديد في عروق المجتمعات البشرية أم بالعكس؟ أنه موضوع خارج عن نطاق بحثنا هذا). ولهذا الغرض، فإن القرآن يدخل ضمن مبحث علم الاجتماع، وضمن المواضيع التي يهتم بها هذا العلم. ومعنى كلامنا أن البحث والتحقيق حول تأريخ العالم خلال 14 قرنا بصورة عامة، ومعرفة المجتمعات الإسلامية بصورة خاصة، بدون معرفة القرآن، أمر محال.
وأما ضرورة معرفة القرآن لكل مسلم مؤمن، فإنها تأتي لكون القرآن، المنبع الأصلي والأساسي للدين والإيمان وتفكر كل مسلم ، ولأنه (القرآن) يهب الحياة حرارة وروحا وحرمة ومعنى. القرآن <ليس؟؟> مثل بعض الكتب الدينية التي تعرض مجموعة من المسائل الغامضة حول الله والخلقة والكون، أو تعرض – على الأكثر – مجموعة من النصائح الخلقية العادية ولا غير، حتى يضطر المؤمنون إلى أخذ أفكارهم ومعتقداتهم ومفاهيم حياتهم من منابع أخرى. القرآن عرض ووضح أصول العقائد والأفكار التي يحتاج إليها الإنسان، على أساس أنه موجود مؤمن وصاحب عقيدة.
وهكذا بين القرآن الأصول التربوية والخلقية والأنظمة الاجتماعية والروابط الأسرية، إلا أنه يبقى التفصيل والتفسير، وأحيانا الاجتهاد، وتطبيق الأصول على الفروع، فذلك موكول إلى السنة أو الاجتهاد (استنباط الأحكام). ولذا تتوقف الاستفادة من أي منبع آخر على معرفة القرآن مقدما. القرآن مقياس ومعيار للمنابع الأخرى، وعلينا أن نطبق الحديث والسنة مع المعايير القرآنية، فلو تطابقت معها قبلناها، ولو لم تطابقها رفضناها.
وأما أكثر المنابع اعتبارا وتقديسا عندنا بعد القرآن، هي: الكتب الأربعة في الحديث(الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، والاستبصار)، وفي الخطب: نهج البلاغة، وفي الأدعية: الصحيفة السجادية، وكل هذه المنابع متفرعة من القرآن ولا نقطع بها كما نقطع بالقرآن، أي أن حديث الكافي: نستطيع أن نأخذ به ونستدل عليه عندما نطبقه مع القرآن، ولا بد أن يتطابق معه ومع تعاليمه ولا يختلف معه شيئا.
كان الرسول الأعظم والأئمة الأطهار عليهم السلام يقولون (بما معناه). اعرضوا أحاديثنا على القرآن، فإن لم تنطبق معه فأعلموا أنها مزورة مجعولة، نحن لا نقول خلافا للقرآن.
أقسام معرفة القرآن
الآن، و بعد أن علمنا ضرورة معرفة القرآن، لا بد أن نرى ما هي طريقة معرفة هذا الكتاب؟
لمطالعة وفهم أي كتاب بصورة عامة، هناك ثلاثة أقسام للمعرفة لا بد منها:
أولا: المعرفة الإسنادية أو الانتسابية
في هذه المرحلة، نريد أن نعرف مدى ضرورة انتساب الكتاب إلى كاتبه، لنفرض مثلا: أننا نريد أن نعرف ديوان”حافظ” أو “خيام”، في المقدمة لا بد من معرفة آن ما اشتهر من ديوان حافظ، له كله أم أن بعض الكتاب له والباقي ينسب إليه، وهكذا بالنسبة إلى خيام أو غيرهما. هنا لابد من الاستعانة بنسخ الكتاب أقدمها وأكثرها اعتبارا. ونلاحظ أن جميع الكتب لا تستغني عن هذا النوع من المعرفة. ديوان “حافظ” الذي طبعه المرحوم القزويني واستفاد فيه من أكثر النسخ اعتبارا، يختلف اختلافا كبيرا مع النسخة الموجودة في كثير من البيوت والمطبوعة في “بمبئي”.
وعندما ما تلقي نظرة إلى “رباعيات الخيام”، ربما ترى 200 (رباعية) في منزلة واحدة ومستوى واحد تقريبا، وإذا كان فيها أي اختلاف فإنه كاختلاف أشعار كل شاعر. مع العلم بأننا لو رجعنا تأريخيا إلى الوراء واقتربنا من عصر الخيام، لرأينا أن المنسوب إليه قطعا يقل عن 20 رباعية، والباقي يشك في صحة انتسابة إليه، أو أنه من نظم شعراء آخرين دون ترديد. وعلى هذا فإن أولى مراحل معرفة الكتاب هي أن نرى مدى اعتبار إسناد الكتاب الذي بين يدينا إلى مؤلفة.
وهل يصح إسناد كل الكتاب أم بعضه إليه؟ وفي هذه الحالة كم في المائة من الكتاب نستطيع تأييد إسناده إلى المؤلف؟ وعلاوة على ذلك، بأي دليل نستطيع أن ننفي بعضا ونؤيد بعضا ونشك في البعض الآخر؟
القرآن مستغن عن هذا النوع من المعرفة، ولهذا فإنه يعتبر الكتاب الوحيد (الذي يصح إسناده) منذ القدم، ولا يمكننا الحصول على أي كتاب قديم قد مضى عليه قرونا من الزمان وبقي إلى هذا الحد صحيحا معتبرا دون شبهة. وأما الموضوعات التي تطرح أحيانا، ومن قبيل المناقشة في بعض السور أو بعض الآيات، فإنها موضوعات خاطئة ولا داعي لعرضها في الدراسات القرآنية، القرآن تقدم على علم معرفة النسخ، ولا يوجد أدنى ترديد في أن الذي جاء بهذه الآيات من الله عز وجل، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جاء بها عنوانا للإعجاز، لأنها كلام الله، ولا يقدر أحد أن يدعي أو يحتمل وجود نسخة أخرى غير هذا القرآن، ولا يوجد في العالم مستشرق واحد، يبدأ – في بحثه عن القرآن – بالتحقيق حول نسخ القرآن القديمة، (فلا توجد هناك نسخ متعددة من القرآن)، وبالرغم من أن هذه الحاجة ( حاجة ملاحظة النسخ القديمة) موجودة لدى التحقيق في التوراة والإنجيل والشاهنامه (للفردوسي) وديوان سعدي وأي كتاب آخر، فإن القرآن لا يقال بحقه مثل ذلك.
والسر في هذا الأمر – كما تقدم – هو تقدم القرآن على علم معرفة النسخ. والقرآن علاوة على أنه كتاب سماوي مقدس وأتباعه ينظرون إليه بهذه العين، فإنه أصدق دليل على صدق ادعاء الرسول ويعتبر أكبر معجزاته.
وإضافة إلى ذلك، فإن القرآن ليس مثل التوراة التي نزلت مرة واحدة، حتى يصح هذا الإشكال: ما هي النسخة الأصلية؟ بل، وإن آيات القرآن نزلت بالتدرج وطوال ثلاثة وعشرين سنة، ومن اليوم الأول لنزول القرآن، تنافس المسلمون على تعلمه وحفظه وفهمه، كما يتهالك الظمآن على شرب الماء، وخصوصا فإن المجتمع الإسلامي وقتئذ كان مجتمعا بسيطا، ولم يكن هناك كتاب لا بد للمسلمين من حفظه وفهمه إلى جنب القرآن.
خلو الذهن، فراغ الفكر، قوة الذاكرة وعدم الإلمام بالقراءة والكتابة كلها كانت الدافع إلى أن تركز المعلومات السمعية والبصرية – لدى الإنسان المسلم وفي ذاكرته تركيزا قويا، ولأجل ذلك، فإن موافقة بيان القرآن مع عواطفهم وأحاسيسهم، أدى إلى تركيزه في قلوبهم كما يرتكز الرسم المحفور في الصخر.
كانوا يقدسونه باعتباره كلام الله لا كلام البشر، ولا يسمحون لأنفسهم أن يغيروا كلمة واحدة، بل حرفا واحدا فيه أو أن يقدموا أو يؤخروا حرفا، وكان كل همهم أن يقتربوا من الله بتلاوة هذه الآيات (تلاوة صحيحة).
علاوة على كل هذا، فإن ذكر هذه النقطة ضرورية، وهي أن الرسول الأكرم (ص) منذ الأيام الأولى، انتخب عددا من خواص الكتاب، ويعرفون باسم “كتاب الوحي”، وتحسب هذه ميزة للقرآن، إذ أن الكتب القديمة لم تكن كذلك، كتابة كلام الله منذ البداية تعتبر عاملا قطعيا لحفظ القرآن وصونه من التحريف.
وهناك سبب آخر لحسن تقبل القرآن لدى الناس، وهو الناحية الأدبية والفنية للقرآن، والتي يعبر عنها بالفصاحة والبلاغة، الجاذبية الأدبية الشديدة للقرآن، كانت تدعو الناس بالتوجه إليه، والاستفادة منه بسرعة، وذلك خلافا للكتب الأدبية الأخرى، التي يتصرف فيها رواد الأدب كيفما يشاؤون، ليكملوها حسبت تصورهم. وأما القرآن، فلا يجيز أحد لنفسه التصرف فيه، لأن هذه الآية:
((وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ)) (الحاقة، الآية 44-46) وآيات أخرى توضح مدى عقوبة الكذب على الله، وعندما تتمركز هذه الآيات في مخيلته ينصرف عن هذا الأمر.
وبهذا الترتيب، قبل أن يرى التحريف له طريقا إلى هذا الكتاب السماوي، تواترت آياته ووصلت إلى مرحلة لا يمكن إنكار أو تحريف حرف واحد منه. ولذا، لا يلزمنا البحث في هذه الناحية من القرآن، كما أن كل عارف للقرآن في العالم لا يرى لنفسه ضرورة البحث في هذا المجال.
هنا لا بد أن نتذكر نقطة واحدة، وهي أنه بسبب سعة نطاق الحكومة الإسلامية، واهتمام الناس الشديد بالقرآن، وبواسطة بعد عامة المسلمين عن المدينة (المنورة) التي كانت مركز الصحابة وحفاظ القرآن، فإن احتمال خطر بروز تغييرات متعمدة أو غير مقصودة في نسخ القرآن كان أمرا واردا، خاصة بالنسبة إلى المناطق النائية على الأقل.
إلا أن فطانة ودقة مراقبة المسلمين منعتا حدوث هذا الأمر. فالمسلمون منذ أواسط القرن الأول للهجرة احتملوا هذا الخطر، ولذلك استفادوا من وجود الصحابة وحفاظ القرآن، ولتجنب أي خطأ أو اشتباه، عمدا كان أو سهوا في المناطق البعيدة، فإنهم استنسخوا نسخا مصدقة (من قبل الصحابة الكبار وحفاظ القرآن) من القرآن، ووزعت هذه النسخ من المدينة إلى الأطراف، ولذلك قطعوا الطريق إلى الأبد من ظهور مثل هذه الاشتباهات أو الإنحرافات، وخصوصا من قبل اليهود الذين يعتبرون أبطالا في فن التحريف.
ثانيا: المعرفة التحليلية
هذه المرحلة تعني بتحقيق تحليلي حول الكتاب، أي توضيح أن هذا الكتاب يشتمل على أية مواضيع، وما هو الهدف الذي وضع له؟ ما رأيه حول الإنسان؟ ما هي نظرته إلى المجتمع؟ وكيفية عرضه للمواضيع وطريقة مقابلته للمسائل المختلفة؟ هل له نظرة فلسفية – أو باصطلاح اليوم – علمية؟ هل ينظر إلى القضايا من زاوية عين رجل عارف أم أن له أسلوبا خاصا به؟ وسؤال آخر أيضا في هذا المجال: هل لهذا الكتاب رسالة ونداء إلى الإنسانية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي هذه الرسالة؟
إن المجموعة الأولى لهذه الأسئلة ترتبط – في الحقيقة – بنظرة الكتاب إلى العالم والإنسان والحياة والموت و ….، أو بعبارة أكمل، ترتبط بمعرفة الكتاب، وفي اصطلاح فلاسفتنا ترتبط بفلسفة الكتاب النظرية. وأما المجموعة الثانية من الأسئلة فتختص بأطروحة الكتاب بالنسبة لمستقبل الإنسان، كيف يريد أن يبني المجتمع البشري، ومن هو الإنسان النموذجي في نظره؟
وعلى أي حال، فإن هذا النوع من المعرفة يرتبط بمحتوى الكتاب، ونستطيع أن نبحث من هذه الزاوية ي <في؟؟> أي كتاب إن كان كتاب الشفاء لابن سينا أو ديوان “سعدي”. من الممكن أن نرى كتابا ليس له نظرة ولا رسالة، أو أن له نظرة بدون رسالة، أو أنه يحتوي على الاثنتين.
وبالنسبة للمعرفة التحليلية للقرآن، لابد أن نرى ما هي المواضيع التي يشتمل عليها القرآن؟ وكيف يعرض القرآن هذه المسائل؟ وما هي استدلالات واحتجاجات القرآن في المستويات المختلفة؟ بما أن القرآن حافظ وحارس للإيمان ورسالته إيمانية، فهل ينظر إلى العقل نظرة ترقب وترصد، ويسعى ليصد هجوم العقل ويكبل يديه ورجليه أم بالعكس ، ينظر أليه دائما نظرة مساندة وحماية (ويستعين به) ويستنجد من قوته؟
هذه الأسئلة ومئات الأسئلة المشابهة التي تطرح ضمن المعرفة التحليلية، توضح لنا وتعرفنا ماهية القرآن.
ثالثا: المعرفة الجذرية
في هذه المرحلة، وبعد معرفة صحة استناد وانتساب الكتاب إلى مؤلفه، وبعد تحليل وتحقيق محتويات الكتاب بدقة، يجب أن نحقق فيما إذا كانت مواضيع ومحتويات الكتاب نابعة من أفكار الكاتب أم أن المؤلف استدان واقتبس من أفكار الآخرين. مثلا، بالنسبة لديوان حافظ، بعد أن اجتزنا مرحلتي المعرفة الإسنادية والمعرفة التحليلية، يجب أن نعرف هذا الأمر: هل هذه الأفكار والمواضيع التي أوردها في الكلمات والجمل والأبيات وأخرجها بأسلوبه الخاص، هل هي من إبداعاته أم أن صياغة الكلمات بهذا الفن والجمال من الشاعر وأن الأفكار من آخر أو من آخرين. وبعبارة أخرى بع <بعد؟؟> العلم بالأصالة الفنية لدى حافظ يجب أن نتيقن بالأصالة الفكرية له أيضا.
هذا النوع من المعرفة بالنسبة لحافظ أو أي مؤلف آخر، معرفة تنبع من جذور أفكار المؤلف، وهذا المعرفة فرع للمعرفة التحليلية. أي أن يجب معرفة محتوى أفكار المؤلف بدقة أولا، ثم نبدأ بالمعرفة الجذرية. وخلافات <خلافاً؟؟> لهذا الأمر، فإن النتيجة تشبه مؤلفات بعض كتاب تأريخ العلوم الذين لم يفقهوا شيئا من العلوم، غير أنهم يكتبون في تأريخ العلوم. أو نستطيع أن نمثل أيضا بأولئك الذين يكتبون الكتب الفلسفية ويريدون أن يبحثوا – مثلا – حول أبن سينا وأرسطو، ووجوه التشابه والاختلاف بينهما، ولكنهم لم يعرفوا مع الأسف ابن سينا ولا أرسطو.
هؤلاء مع مقايسة بسيطة، وفور تعلمهم بعض المشابهات اللفظية يجلسون على منصة القضاء، مع أن في المقايسة يجب أن يدرك عمق الأفكار، ولمعرفة عمق أفكار كبار المفكرين أمثال ابن سينا وأرسطو يلزمنا عمرا كاملا من الزمان، وإلا فما نحصل عليه ليس سوى كلمات تخمينية أو تقليدية.
في التحقيق حول القرآن ومعرفته – بعد إجراء المطالعة التحليلية حول القرآن – يأتي دور المقايسة والمعرفة التأريخية، أي أننا يجب أن نقارن القرآن وما يحتويه بالكتب الأخرى الموجودة في ذلك العصر، وخصوصا الكتب الدينية، ويلزمنا في هذه المقارنة ملاحظة جميع الشروط والإمكانات (الخاصة بذلك العصر). مثل مدى علاقة شبة الجزيرة العربية بسائر البلدان، وعدد المتعلمين الذين كانوا يعيشون في مكة وقتئذ و….، ثم نستنتج أن ما في القرآن هل يوجد في الكتب الأخرى أم لا؟ وإن كان يوجد فبأية نسبة؟ وتلك المواضيع التي تشبه بقية الكتب هل هي مستقلة أم مقتبسة؟ وما هو دور هذه المواضيع في تصحيح أخطاء تلك الكتب وتوضيح انحرافاتها؟